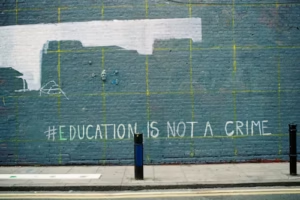أ.د. شفق يوسف جدوع
دكتوراه في اللسانيات ، جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات ، العراق .
تقع مساحةُ هذا البحث حيثُ تحاول الهرمنيوطيقا الحديثة وتحديدا الفلسفية مقاربة قضايا اللغة بمنهج أنطولوجي بديل عن منهج اللسانيات الموضوعي، هكذا قدّم هانز جورج غادامر مقاربته التي تجيب عن التساؤل اللساني حول طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر، ومن ثم حول إشكالية وحدة العالم وتعدّد اللغات عن طريق إعادة النظر في طبيعة كلٍّ منهما على أساس تاريخي، كاشفا عن المكانة المحورية التي تحتلّها اللغة وهي تمارس دورَها بوصفها وسيطا بين كلية العالم وتناهي الإنسان وتاريخيته، ومن ثم تناهي وتاريخية تجربته في العالم، وهو جدل (الكلي والمتناهي) الذي تتوسطه اللغة بوصفها القادرةَ في الوقت نفسه على استيعاب الكلي والتاريخي المتناهي. من أجل ذلك أقام الهرمنيوطيقا على أساس تاريخي هو تناهي الوجود، ثم أقام الوجودَ على أساس لغوي بوصف اللغة سجلَ التناهي، وهي ما يشكّل العالَم ويضم تناهيه، ويؤرخ هذا التناهي ويحتفظ به ويحفظه، مستلهما مفهوم “الفيض” ذا الطابع الأنطولوجي.
نقول
بحثُ مشكلة اللغة في إطارِ قضيةِ الوحدة والتعدّد/التنوع يعني تناولَ مشكلة حقيقة اللغة من منظارِ التنوع اللغوي في لغات البشر. وهي قضية طُرحت للنقاش منذ أفلاطون الذي كان يرى أن تنوعَ اللغات البشرية لا يشكّل شيئا ذا بالٍ إزاءَ الحقيقة الواحدة والكلية للغة البشرية، وقد اعترف علمُ اللغة المقارن بالتنوع والتعدّد بوصفه تنويعاتٍ عقليةً لاستخدام القدرة اللغوية، وهكذا يرتبط ما هو فردي وخاص بلغةٍ معينة بحقيقةٍ كلية للغة الإنسانية، يستمدّ منها معناه. وما يشوب هذه الطريقةَ في فهم اللغة عند غادامر هو تجريديتُها العالية ومثاليتُها الذاتية وشكلانيتُها، لذلك قدّم لنا مقاربةً هرمنيوطيقةً ذاتَ طابعٍ أنطولوجي عابرٍ لموضوعية المقاربة اللسانية.
الطابع اللغوي للفهم
العلاقة الجوهرية القائمة بين اللغة والفهم
يقرّر غادامر أن الفهمُ لا يتحقق بمعزل عن اللغة، ومن أجل أن يثبت عمقَ العلاقة بين الفهم واللغة يدقّق في تحليل الحالة التي يكون فيها – أو نشعر فيها – بأنّ اللغةَ عاجزةٌ عن التعبير عمّا نفكّر فيه أو عن أفكارنا، ومن ثم يكون لدينا قناعةٌ في أنّ التفكير يتجاوز اللغةَ، ويعلو على قدرة اللغة على التعبير عنه، ما يوحي بالانفصال بينهما، وبوجودٍ للفكر مستقلٍّ عنها، مثلما تبدو هذه الحالةُ كما لو أنّنا نبني عليها نقداً لغوياً شخّص عجزَها وقصورَها ومحدوديتَها أمام فكرٍ يعلو عليها ولا تتمكن هي من استيعابه وشموله. إزاء هذا، يؤكد غادامر أن طاقةَ اللغة التعبيرية لا تقوّم بإمكاناتِ الفرد التعبيرية وطاقتِه الخاصة، ذلك أن اللغةَ مدارٌ تداولي للمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد، ونتاجٌ للفهم المشترَك لهذا المجتمع وخصائصه التي لم تكن نتاجَ فردٍ واحد، بل تلقاها كلُّ فرد من تاريخٍ استعمالي طويل نجحت به اللغةُ في أن تكون نظاماً يتخطى استيعابَ الفرد من جهة، ويسخر من الانتقادات الفردية، وأن الإمكاناتِ التعبيرية – التي تملكها اللغة – أكبرُ بكثيرٍ من المعرفة التي يملكها فردٌ ما لأنها ذاتُ طابعٍ فردي محدود، فمعرفتُه هي نتاجُ إمكاناته المحدودة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحتضن اللغةُ – في محيط كلِّ جماعة لغويّة – الفهمَ المشترَك الذي يشكّل هويّةَ هذه الجماعة، وملامحَ هذا الفهم وحدودَه المائزة التي تحمل أو تكشف خصائصَ البيئة الاجتماعية التي تتداول تلك اللغةَ وتستعملها، ما يشكل بمجموعه (مخططات) مفاهيمية، توجّه الفهمَ الفردي في إطار الجماعة، مثلما تفرض حدوداً على اللغة في هيأة مخططات لغوية، فاللغة- بعد هذا – نظامٌ قارّ لا ينشؤه الفردُ بل يتلقّاه من محيطه الاجتماعي كما هو، بوصفه نتاجاً اجتماعياً من مجموعة من المواضعات اللغوية التي تختزن مواصفاتٍ معنويةٍ قارّة، ومن ثم مخططاتٍ للفهم، وحين تحاول المعرفةُ الفردية تجاوزَ تلك الحدود، وتجاوزَ إمكاناتها المحدودة، ومحدِّدات الفهم الاجتماعية القارّة في اللغة، التي توجّه استعمالَ اللغة في إطارها، تبدو اللغةُ عاجزةً عن الإحاطة بالفكرة، لأنّ كسرَ مخططاتِ الفهم السابقة المعطاة سلفاً عن طريق لغة الجماعة، يحتاج إلى لغةٍ بديلةٍ تنجح في التعبير عنه، وهي لا تكون في العادة مُمتلَكةً للمتكلم بفعل انشغال ذاكرته القوية بمواضعات اللغة المعطاة، ومن ثمّ لا يشير نقدٌ كهذا إلى قصورِ اللغة عن الفكر وانفصالِه عنها، بل العكس، إنّه يؤكد الصلةَ العميقةَ بينهما، مثلما أنّ النقدَ ذاته يجد نفسَه في اللغة، ولا يكون إلاّ بها، وعليه لا فهمَ بلا لغة، ولا لغةَ بلا فهم، ولا فكرَ بلا لغةٍ مثلما أن لا لغةَ بلا فكر. وهو ما يؤكده غادامر بقوله: ((اللغة هي لغة العقل نفسه))(غادامير، 2007، ص526) لكنّ هذا لا يفترض أنّ للعقل لغةٌ واحدةٌ لأنّ الواقعَ يقول بوجودِ لغاتٍ بشريةٍ متعددةٍ ومختلفة. وإذا كان للعقل شموليةٌ تتجاوز اختلافَ اللغات وحدودَ كلِّ لغة كما يقول غادامر فإن للغة – من جانب آخر – شموليتَها الخاصة التي تجاري بها شموليةَ العقل ذاته. يتّضح هذا في امتلاك القدرة على فهم النصوص المكتوبة بلغاتٍ أجنبية غير لغة القاريء الأم. ويتّضح أيضاً في فهمِ النصوص التراثية القادمة من أزمان غابرة. وما ينجح في إظهار شمولية كلٍّ من اللغة والعقل على نحوٍ يكشف شموليةَ التجربة التأويلية، فبالتأويل يتجاوز العقلُ حدودَ اللغة، ليتشكّل تأملياً باللغة.
تقارب اللسانياتُ هذه المشكلةَ بطريقتها الخاصة التي تمنح بموجبها للّغة، في حدود الجماعة الناطقة بها، قدرتَها الخاصة على التعبيرِ عن كلِّ شيء. وبذلك فإن في اللغاتِ قدراتٍ خاصةً على التعبير عن كلِّ شيء، بمعنى أنّ (كَّل شيء) يجد طريقتَه الخاصة في التجلي بواسطةِ خصوصيات كلِّ لغةٍ من اللغات. لكنّ المشكلةَ التي تطرحها الهرمنيوطيقا على اللسانيات هي: من أين تأتي القدرةُ على الفهم (فهم كل ما يُكتب) على الرغم من اختلاف اللغات؟ إنّها تأتي – بالتأكيد – من وحدة أو شمولية الفكر والكلام أيضاً. أما التجربةُ اللغوية للعالم، وبسببٍ من نمط علاقتها الأنطولوجية به (العالَم) فإنها تملك القدرةَ على الإحاطة بكلِّ ما هو نسبي فيه وبذلك فهي محيطةٌ بكلِّ تجارب الإنسان في العالَم، ما دام العالَمُ يتشكّل لغوياً، وأن العقلَ يشكّل العالَمَ لغوياً من خلال رؤيةٍ معينة. فكلُّ موضوع ينتمي لهذا العالَم ، وكلُّ شيء مشمولٌ بهذه الإحاطة، ما يجعل اللغةَ قادرةً على تقديم العالَم بوصفه(كلا) .
“كلية العالم اللغوية” أو العالَم كما تقدمه اللغة بوصفه(كلا)
ليس العالَم كما تكشفه اللغةُ التي تشكّله “وجودا في ذاته” مثلما تفترضه التجربةُ العلمية، وليس “النسبي” الذي تستوجبه موضوعيةُ التجربة العلمية، لأن اللغةَ بتشكيلها إياه تمنحه نمطاً من الوجود يتخطى المثاليةَ والموضوعية في الآن ذاته، فهو لا يقع في ذاته خارجَ حدود تجربتنا فيه، ووراءَ حدود معرفتنا، مثلما لا يخضع لهذه المعرفة نتيجةَ توافر إمكانية اتخاذ زاويةِ نظرٍ منه بحيادٍ تام. وبسبب من نسبياتها العديدة لا تتمكن التجربةُ العلمية من استغراقه وشموله ومن ثم تقديمه بوصفه(كلا)، وبذلك تستغرق اللغةُ عالَم الانسان وتجربتَه فيه، وتجربتُها هي الوحيدةُ القادرةُ على تقديمه بنحوٍ لا ينفصل عنه ((لأنه لا توجد لزاوية نظر خارج تجربة العالم في اللغة يمكنه أن يصبح فيها موضوعا))(غادامير، 2007، ص587) في الوقت نفسه يشخّص غادامر نقطةَ الضعف الأهمّ في الدرس اللغوي المقارن الذي اتخذ بنياتِ اللغات البشرية موضوعاً لاهتمامه وبحثه، إذ إنه في الوقت الذي ينطلق فيه من مبدأ أن كلَّ لغةٍ هي رؤيةٌ خاصة للعالَم، وأن كلَّ لغةٍ بعد هذا تقدّم العالَم من زاويةِ رؤيتها الخاصة، فإن نتائجَ مقارنة بنيات اللغات لا يمكن أن يؤدي في آخر مطاف البحث فيه الى ما يمكن أن نسميه أو نعدّه تجميعاً لملامح العالَم المستمدةِ من اللغات المتنوعة بوصفها رؤىً متنوعةً له، لأن نتيجةً كهذه تستوجب أو تتطلب أن تكون كلُّ رؤيةٍ ومن ثم كلُّ لغةٍ محاولةً نسبيةً لبلوغ العالَم القائم على نحوٍ مكتمل خلف جميع الرؤى. في الوقت ذاته، لاتتيح مقارنةُ بنيات اللغات لعلم اللغة أن يمتلك معرفةً بالأشياء والعالَم خارج إطار اللغة ذاتها من موضعٍ مجرّدٍ يتخذه إزاءها، ومن ثم لا تُظهِر مقارناتُه اللغويةُ للغات (بوصفها رؤىً متنوعة للعالَم) لا تُظهِر العالَمَ بوصفه (الوجود في ذاته). هكذا تتفوق وقائعيةُ اللغة على موضوعية العلم، لأن تشكيلَ اللغة للعالَم يحدث للإنسان بسبب امتلاكه القدرةَ على اتخاذِ مسافةٍ من البيئة التي يحيا ضمن شروطها. هذه المسافة التي يتخذها الإنسانُ هي اللغة، لأنها ليست سوى الرؤية التي يعي بموجبها هذه البيئةَ المحيطةَ ويفهمها، وبموجبها يشكّل عالَمه الإنساني، ومن ثم لا تنطلق وقائعيةُ اللغة من تحييد الذات وتغييبها وتخطي الاعتراف بدورها في عملية الإدراك مثلما تفعل موضوعيةُ العلم، وهو ما نجد أثرَه ظاهراً في نزوع العلم الى تحييد اللغة وتجريدها بتحويلها الى رموزٍ محددة الدلالات والمعاني، مثلما في لغة الرياضيات مثلا، وهي محاولاتُ هيمنةٍ متساوقةٍ مع محاولات هيمنة العلم على العالَم والأشياء، وهو ما يميز نمطَ المعرفة العلمي.(غادامير، 2007، ص588).
لا عالَم بلا لغة، مثلما أن لا لغة بلا عالَم
وهذا لا يعني أنهما يتخالقان، أي يخلق أحدُهما الآخر، فاللغةُ هي المسؤولةُ عن العالَم الذي تمارس فيه وبه وظيفتَها الأساسيةَ ذاتَ الطابع الأنطولوجي. وهذه العلاقةُ الأنطولوجية التي تجمعه باللغة تجعله نحواً من الفضاء المفتوح الذي ينكشف فيه كلُّ شيء، ما يعني فضاءَ فهم، وهو ما لا يتوافر عليه الحيوانُ بامتلاكه وسائلَ تواصلية خاصة؛ لأنها الوحيدةُ القادرة على إكسابه موضوعيةً خاصةً غيرَ التي يمنحها إياه المنهجُ العلمي في التفكير، بتحريرها إياه من قبضة الذات والذاتية وامتلاكها وسيطرتها التي تجعله شيئاً من أشيائها، وموضوعًا من موضوعاتها، تؤسس له قيمةً مستمدةً من المسافة (البينذاتية)، لا بوصفها ما يتوسط الذاتَ وموضوعَها (عالمها)، بل بوصفها مساحةَ المشترَك الذي يؤسس قاعدةَ الفهم العامة، وهو بذلك سابقٌ على عالَم التجربة العلمية، وعالَم المقولات الفلسفية والأطر الموضوعية، لأنه ينتمي انتماءً أصيلاً لخبرة الإنسان المباشرة في الحياة وتجربته المعيشة.
إن اللغةَ ليست خبرةً من بين خبرات، بل بوصفها خالقةَ للعالَم فهي الأفقُ الذي تكون كلُّ خبرةٍ في العالم ممكنةً في ظله، فـ ((الخبرة ليست شيئا ما يأتي سابقا على اللغة، بل الخبرة نفسها تحدث في اللغة وخلال اللغة))(غادامير، 2007، ص345). هكذا لا تمثل اللغةُ حقلاً خاصًا من حقول التجربة الإنسانية في العالم ينغلق على ذاته لتمتاز هويتُه الخاصة عن الحقول الأخرى، بل هي حقل ُكلِّ الحقول، ولو عدنا مع غادامر إلى المرحلة التي يواكب فيها تعلمُ اللغة التعرفَ إلى العالم المحيط لوجدنا أن امتلاكَ اللغة هو شرطُ ألفة الوسط الذي يحيا فيه الطفل، فالطفلُ يرى أمَّه مفهومًا للأمومة أو الانتماء حين ينطق كلمة (ماما)، ولذلك تريد الأمُّ من طفلها أن ينطقَ الكلمةَ لا لأنها (الكلمة) رمزٌ صوتي بل انتماءٌ لها، وهكذا كلُّ المفاهيم، فهي ليست أصواتًا كما يراها العلمُ بل مصاديقَ تلقائية تحدث في كيان الإنسان؛ لأن اللغةَ تمتلك امتيازَ توسط المشترَك المسؤول عن وجود شيء اسمه (العالَم) وعن إمكانية تجلّيه عن طريق (الفهم )، ولتحقّق عودةٌ كهذه الغايةَ منها يكملها غادامر بعودةٍ إلى وصف أرسطو لظاهرة تعلم اللغة البشرية التي لا يعدّها اكتسابًا للكلمات بقدر ما يعدّها اكتسابًا للمفاهيمِ الكلية، وللقدرةِ على اختزال المشترَك والواحد في اللامتناهي من الظواهر المدرَكة التي تختزنها الذاكرة، ومن ثم ومن خلال مراكمة الخبرات الإدراكية توحّد تجربةُ الإنسان نفسَها في هيأة مفاهيم كلية يدرك بها الانسانُ العالمَ والأشياءَ، بانطباق هذه المفاهيم الكلية على مصاديقها، وهي عمليةٌ غيرُ مُدرَكة تحدث تلقائياً، ولا تخضع لوعي فردٍ من الأفراد ولا ينتجها تجميع الوعي الخاص بكلِّ فردٍ مع غيره من الأفراد، لأنها (عملية تكوين المفاهيم الكلية) تزامن امتلاكَ اللغة والدخولَ في عالَمها، لذلك هي مثل عملية (التكلم) لا تخضع لوعي فردٍ خاص ولا تقاس به بوصفه معيارا لها ولا يتنبّه إليها الوعيُ في أثناء حدوثها(غادامير، 2006، ص113-115)، وهو توازٍ يمنح الإنسانَ القدرةَ على الكلام لأنه يمنحه القدرةَ على إظهار الغائب ليمكّن الآخرَ من إدراكه كما لو كان حاضراً، وهو أمرٌ تستند إمكانيةُ حصوله وجدواها إلى المشترَك المفاهيمي، ومن ثم فإن قدرةَ الأفراد في مجموعة لغوية معينة على التفاهم بواسطة اللغة تستند إلى امتلاكهم مفاهيمَ مشتركة في إطار بنيةٍ بشرية واجتماعية خاصة منظمة، ولا يستنفد امتلاكُ المفاهيم المشتركة قضايا الوجود الإنساني، فهو لا يستنفد وجودَ اللغة، إذ لا يندّ أيُّ حدثٍ لغوي عن الاستناد إلى المشترَك المفاهيمي، ثم إلى التعبير عن شواغل الوجود الإنساني ومشكلاته وهمومه وأسئلته(عون، 2004، ص 149). وهي ذلك البعد الخفي الذي يمثّل تمثيلاً جوهرياً بنيةَ الاجتماع الإنساني. وإذا كانت كلُّ تجربة للإنسان في العالَم لا تنفصل عن التجربة اللغوية بل تتضمنها على نحوٍ يجعلها في الفهم مشروطةً باللغة فإن ما يمكن أن يُفهم هو اللغة؛ لأن اللغةَ هي الوسيط الوحيد الذي يترجم كلَّ شيء دلاليًا، أي يمنح كلَّ شيء دلالتَه الخاصة، والهرمنيوطيقا هي القادرة على تجليةِ جميع الدلالات( تأويلها) في إطارها الثقافي الخاص، و منحِ الفكر مهمةً أخرى غير موضعة الأشياء في العالَم، تتمثل في جعلها قابلةً للفهم، أي تجلية حدثِ كينوتها ونمطِه السابق على كلِّ تصور.
الكلي في التجربة التأويلية الهرمنيوطيقية
على أساسٍ من النمط الانتمائي الذي يراه غادامر لعلاقة الذات بالموضوع، لم يعد الفهمُ فعلاً يمارسه العقلُ على الشيء بوصفه موضوعاً، كما قلنا، بل صار حدثاً وتجربة، يتم فيهما “تجربة الشيء ذاته” بدلا من إخضاعه لفعل مُمنهَج. إن للشيء كينونةَ اللغة، وهي البنية الأنطلوجية التي توفر شرطَ الفهم، والتي لا يكون الشيءُ بموجبها مجردَ (حاضر) أمامنا، بل شيئا له وجودٌ ذو طبيعة دلالية، أي بوصفه معنى. فما يمكن أن يُفهَم هو فقط المعنى؛ وبنية الفهم الكلية هي اللغة. وهو ما يوسع حقيقةَ اللغة خارج إطار الكلمات المنطوقة التي لا تكون (كلمات) إلا لتضمنها حقيقةَ اللغة.
وحدة اللغة والفكر
كانت مقاربةُ همبولدت أكثرَ عمقاً حين فسّرت تنوّعَ اللغات بتنوّع رؤى العالَم، بوصف اللغة – أية لغة – تبدي – من خلال خصوصيتها – رؤيةَ الجماعة البشرية الناطقة بها للعالَم. ومن هذا المنطلق ذاته فسّرت هذه المقاربةُ وحدةَ اللغة والفكر، بمعنى أنّ كلَّ لغة تمثّل الدائرةَ الخاصّة التي توحّد اللغةَ بالفكر ضمن إطارها الخاص. ومن ثمّ تعني اللغاتُ المختلفة صورًا وأنماطًا مختلفة للوحدة بين اللغة والفكر، وغادامر يتبنّى عمقَ رؤية همبولدت لغرض البحث عما يمثّل الوحدةَ بين اللغة والفكر، ولكنه يمضي الى طريقٍ آخر ليصل الى نتيجة مؤداها: أن للوحدة شكلاً واحدا ونمطًا واحدًا لا أنماطا مختلفة، أما همبولدت فيرى أن تنوعَ اللغات يعني تنوعَ الرؤى تبعًا لخصوصيات الأمم التي تستعملها لا تنوع رموزها الصوتية وطرائق تعبيرها الأسلوبية.
إذا كانت اللغة قريبةً إلى هذا الحدّ من العقل، فإنها بذلك أيضا قريبةً من العالَم والأشياء التي يعرفها العقل. وصاحبُ اللغة يألف لغتَه إلى حدٍّ يجعله يشعر معه ألا قدرةَ لأيةِ لغةٍ أخرى على التعبير عن تلك الأشياء إلاّ هي، وكأنّ اللغةَ تتحدّد بالأشياء. فكما أنّ الشيءَ فريدٌ بذاته، تكون الكلمةُ الدالة عليه كذلك. لذلك ما يحدث عند الترجمة هو عبارةٌ عن صياغةٍ أكثرَ منه نقل. هنا يقرر غادامر أن الوحدةَ الحميمة بين الكلمة والشيء فضيحةٌ تأويلية، وأنّ صاحبَ اللغة ليس سجينَ لغته، بدليل قدرته على فهم نصٍّ مكتوب بلغة أجنبية. وهذا يعني: أنّ غادامر يقول بوحدة اللغة والعقل، لكن لا يقول بأنّ هذه الوحدةَ هي سجنُ العقل. فالفكرُ متوحد باللغة، لكنّه ليس سجيناً بها. ويؤكد أنّ العقلَ له شموليةٌ تعلو على أيّة لغةٍ معيّنة.
وتشخّص اللسانياتُ هذه المشكلةَ بالطريقة الآتية:
إذا كانت اللغاتُ متنوعة مختلفة، فكيف يمكن لكلِّ لغةٍ أن تتحدّث عن كلِّ شيء؟ وإجابةُ اللسانيات هي: إنّ كلَّ لغة تقوم بذلك بطريقتها الخاصة. بمعنى أن تعدّدَ اللغات واختلافَها هو في حقيقته اختلافٌ في الطرائق التعبيرية، واللغُة تنجح في قول كلِّ شئ في حدود طريقتها الخاصة. وسؤالُ غادامر هو: على الرغم من تعدّدِ اللغات واختلافِ طرائقها في التعبير، تبقى إمكانيةُ فهم كلِّ ما يكتب متوافرة، ما يشي بوحدةِ الفكر باللغة، مؤكدا هنا أنّه يحاول الاتجاهَ اتجاها عكسيا مع ما تحاول اللسانيات بحثه فيقول: ((فنحن معنيون بنقيض ما تحاول اللسانيات أن تبحثه))(غادامير، 2007، ص527). هذه الوحدةُ كانت – بالنسبة للّسانيات – مقدمةً منطقية، إن اتحادَ اللغة والفكر هو التجريدُ الذي يجعل اتّخاذَ اللغة موضوعا مختلفا. ويصف هذا الكيفيةَ المنهجية التي تتعامل بها اللسانياتُ مع اللغة بوصفها موضوعا، بمعنى أنّ ما يخصّ اللغة هو افتراضاتٌ منهجية وتجريدات تمكّن من التعامل مع اللغة بوصفها موضوعا لا تجربة.
الإضافة التي تمكّن هاردر وهمبولدت من تقديمها هو أنّهما لم يريا في اختلاف اللغات اختلافا في طرائق التعبير والإبلاغ، بل اختلافا في الطرائق التي يُرى بها العالم، مؤكدين أنّ اللحظةَ التي تكون فيها اللغةُ موضوعا للوعي، منتقلةً من اللاوعي الذي يحفظها في مستوى حياتها المرتبطة بالفهم، تكون قد افتقدت فيه مضمونَها، وتحولت إلى تجريدٍ ينتزعها من دلالتها الكلية ليمنحها دلالةً رمزية شكلية. فاللسانياتُ علمٌ، ولابدّ لكلِّ علمٍ من موضوع يجرّده ليبحث فيه، أما هيدغر و غادامر فلهما طريقُهما الخاص وعمقُهما الاستكناهي المتأتي من كونهما فيلسوفين، والفلاسفةُ يبحثون في الوجود نفسه بوصفه وجودا واقعا لا في كونه موضوعا، ذلك أن الوجودَ ليس موضوعا مجردا بل واقعا متحققا.
خلاصة القول :
وبعدُ، فقد تمخضت رحلةُ البحث عما يمكن إجمالُه في الآتي:
- للعلاقةِ بين العالَم واللغة نمطٌ أنطولوجي، لا يعود للعالَم بموجبه وجودٌ متحقّقٌ سابقٌ على اللغة.
- لا وجودَ لعالَم خارجَ إطار اللغة لأن العالَم هو ما تنتجه خبرتُنا الحياتية إنتاجًا لغويًا، ولا وجودَ للفهم خارج إطار اللغة، ولا وجودَ للغة خارج إطار الفهم والعالَم.
- لا يمنح التنوعُ اللغوي قيمةً معياريةً تجعله دليلاً على مدى اقتراب لغة ما، بخصائصها الفريدة، من تمثيل العالَم القائم بذاته خلفها، هو الأقرب لكماله. لأنها لا تستنفده، فتبقى قادرةً على الاغتناِء بالرؤية الأخرى، والاتساعِ بها، ، وإقامةِ تعالقٍ قائمٍ على المشترك بينهما على نحوٍ لا يكون الانفتاحُ بموجبه مغادرةً للذات بل اثراءً لها.
- تتجاوز اللغةُ بطابعها الشمولي للخبرة الحياتية دائرةَ الحكم المنطقية التي يكون الموضوعُ بموجبها صادقا أو كاذبا، ما يجعلها تتمتع بالإطلاق مقارنةً بنسبية التجربة العلمية.
المراجع :
• غادامر، هانز جورج ،2007، الحقيقة والمنهج الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم، راجعه عن الألمانية: د.جورج كتوره، دار أويا، ط1، طرابلس-الجماهيرية العظمى.
• غادامر، هانز جورج، 1427هـ – 2006م، فلسفة التأويل الاصول المبادئ الاهداف، ترجمة: محمد شوقي الزين، الدار العربية للعلوم منشورات الاختلاف، المركز الثقافي العربي، ط2،.
- عون، مشير باسيل،2004، الفسارة الفلسفية بحث في تاريخ علم التفسير الفلسفي الغربي، دار المشرق، بيروت، ط1.