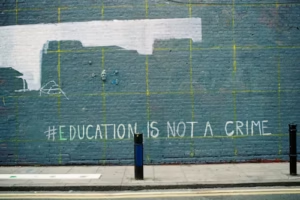د. إسماعيل حامد إسماعيل علي
باحث في التاريخ الوسيط
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للسياحة والفنادق (القاهرة)
مُلخص الورقة
ترصد هذه الورقةُ دور “الكوارث الطبيعية” مثل: الزلازل، والبراكين، والأوبئة، وكذلك الجفاف، والمجاعات…وغير ذلك في حركة التاريخ البشري، ومن ثم تأثيرها فيما يُعرف بين العلماء حديثًا بمصطلح “التحقيب التاريخي” وذلك حتى نهايات العصر الوسيط. وهو ما يعني أن بعض “الأحداث الطبيعية”، قد تغير بشكلٍ واضح مجرى الأحداث التاريخية، ولعل من ذلك أن بعض الظواهر قد تؤدي لاندثار بعض المدن أو اختفائها من الوجود، أو حتى الشعوب، وربما يؤدي بعضها إلى انهيار حضارات كبرى كانت مزدهرة، وغير ذلك من الأحداث التاريخية المهمة.
الكلمات المفتاحية: (الكوارث الطبيعية، التحقيب التاريخي، العصر الوسيط الزلازل، البراكين، الأوبئة، المجاعات..الخ).
Abstract of the Paper
This paper is dealing with the impact of the Natural Disasters such as Earthquakes, Volcanoes, Plagues, Drought, famine..etc., on the History of Man, therefore to show its influence on what is called Historical Periodization till the end of the Medieval Age. That would mean that some Natural Events could change the itinerary of Human History so that some of these Events could vanish some Cities from existence, also hide some People from the Historical Scene, at the same time some Natural Events could cause to put an end to some grand Civilizations…
Key Words; Natural Disasters, Historical Periodization, Medieval Age Earthquakes, Volcanoes, Drought, Famines …
المقدمة:
تهدف الورقةُ لدراسة تأثير “الكوارث الطبيعية” على تاريخ الإنسان، ودورها في توجيه مسار الحدث التاريخي، ولاريب أن الأحداثُ المأساويةُ التي يمرُ بها العالمُ الآن تستدعي من دارسي التاريخ ذوي الفِطنة والحَذق، نظرةً مُختلفة الأبعاد، تتماهى مع تقلبات الأحداث التي نعاصرها، بعد حقبة “كوفيد-19”. ويمكن لتلك الرؤيةُ التاريخية أن تُسهم بشكلٍ أو بآخر في خدمة باقي البقية من العُلوم الإنسانية في ذات الآن، إذ إن تلك العلوم في حاجةٍ ماسة لرُؤية المؤرخين في خضم تلك المرحلة التاريخية الفاصلة. ومن المعلوم أن “الحدث التاريخي” يتكون من عناصر الزمان، والمكان، والرابطُ بينهما “الإنسان”، فهو صانعُ الحدث، ويُشكل العامل المؤثر في مجريات الأحداث بصفةٍ عامة. غير أن “الطبيعة” قد يكون لها دورٌ لايقلُ أهميةً عنه، وربما تتفوقُ عليه أحيانًا في صناعة أحداث ربما يقف الإنسانُ أمامها حائرًا، بل وعاجزًا أحيانًا أُخرى. ولاريب أن بعضُ “الكوارث الطبيعية” كالزلازل، والبراكين، والأوبئة، والمجاعات..الخ ربما تتسبب في إسقاط حضاراتٍ، أو إضعاف أُخرى، أو أُفول أُمم كانت مُزدهرةً، ولم يكن مُتصورًا أن تختفي بين عشيةٍ وضُحاها، وهو ما يُؤثر بالطبع في مسار “التحقيب التاريخي”. فالعديد من الأحداثٍ وقعت على هذا النحو بسبب كوارث الطبيعة، ولعل منها اختفاء شعب “الأطلانتس” بسبب أحد الزلازل، كما واختفى الكثير من تُراث “البحر المتوسط” بسبب زلزال آخر، واختفت مدنٌ بسبب البراكين، وضعُفت إمبراطوريات ودول بسبب الأوبئة والطواعين..إلخ. ولعل أهمية هذه الورقة ترجع لنوعية الفكرة التي تطرحها، ولقلة الدراسات التي تناولت دور “الكوارث الطبيعية” في مسار “الأحدث التاريخية”، ومن ثم أثرها فيما يُعرف بـ”التحقيب التاريخي”.
أولاً- مَفهومُ التَحقيبِ التَاريخي ودلالتهُ الاصطلاَحية واللُغَوية:
تُعد “الكوارثُ الطبيعية” من أبرز الأحداث التي قد تُؤثر في التاريخ الإنساني بشتى صورها، وأنماطها، وتلك الأحداثُ الاستثنائية لها أثرها في صيرورة “الحركة التاريخية”، وهو ما يُعرف بين الدارسين المُحدثين بـ”التحقيب التاريخي”. ومُصطلح “التَحقيب” يُشير بصفة عامة لمحاولة تقسيم مراحل تاريخ الإنسان على هذه الأرض لـ”حِقبٍ” زمنية مُتعاقبة، حقبةٌ تلو الأخرى، وهو “تحقيبٌ” قد يختلف بالطبع من مؤرخٍ لآخر، وكذا من منطقة إلى أخرى. ومن الناحية اللغُوية: فإن جمع كلمة “حِقبة”: “حقب”[1]، و”الحقبة” يُعنى بها “المرحلةُ” أو “الفترة” من الزمن. ويَجدرُ بنا أن نستخدم بعض طرائق علماء “الفيلولوجيا”[2] لتفكيك بعض الألفاظ اللُغوية والمصطلحات المرتبطة بتلك الفكرة التي نحن بصددها لاسيما لفظ “التَحقِيب”، وهو مُشتقٌ من الأصل اللغُوي أو الجذر اللغُوي: (حَقَب)، ومنه لفظ: “الحُقب”، ومفردها: “حُقبة” (بالضم وسكون القاف)، ويُقصد بها في الغالب فيما تذكر معاجم اللغُة: “ثمانون” سنة، وقيل إيضًا: إن مدة الحُقبة الزمنية قد تمتد لأكثر من ذلك[3]. أما جمع “الحِقبة” (بكسر الحاء): حِقاب، والحِقَب: يُعني بها فيما يُقال: “السُنون”، و”الحُقُب” (أي باستخدام ضمتين): يُقصد بها “الدهر”، والجمع: “أحقاب”[4]. وتذكر بعض المعاجم أن ما يُطلق عليها “الحقبة من الدهر”: هي مدةٌ لا وقت لها، وقد قيل أيضًا في ذات الشأن إن الحقبة بالكسر يُقصد بها السنة، والجمع: حِقب[5]. وكل هذا يُشير إلى ثراء لغة الضاد بأصل لفظ “التحقيب”، وهو اللفظُ الذي يُشكل محور هذه الورقة. وأما لفظ “التحقيب التاريخي”، وهو المصطلح الأهم في دراسة تلك الإشكالية، فمن المؤكد أنه مصطلحٌ يختلفُ من بلدٍ لآخر، لأن “الحقب التاريخية” في حياة أي من الشعوب، أو الأُمم، بصفةٍ عامة تختلفُ عن مثيلاتها لدى الأمم والشُعُوب الأُخرى، وعلى هذا فـ”التحقيب” يبدو متباينًا بين الشعوب، وهذا دون ريب في الإطار الإقليمي فيما يخصُ ما يُقال له “التأريخ المحلي” لأي بلدٍ من البلدان، فـ”التحقيب التاريخي” في مصر على سبيل المثال ليس كمثيله في بلاد العراق، رغم أن حضارتيهما كانتا الأعرقُ والأقدمُ عبر التاريخ. ورغم ذلك البون الواضح …فيما يُمكن أن يُطلق عليه “التحقيب المحلي”، يحاول العلماءُ وضع تحقيبٍ تاريخي جامع قدر الإمكان، يمكنه أن يجمع المراحل، أو “الحقب” التاريخية، لأكثر الشعوب في ذات الآن.
وعلى هذا نخلُص لوجود نوعين رئيسيين من “التحقيب التاريخي”، أولهما: “التحقيب المحلي”، أو “التأريخ الإقليمي”، وهو ذلك “التحقيب” الذي يرتبطُ ببلدٍ من البلدان، وثانيهما: “التحقيب العالمي”، أو “التحقيب العام”، وهو الذي يرتبط ببلاد العالم كافة، أو أكثرها من ناحية أخرى. ويرى الباحثُ أنه رغم توافق أكثر الدارسين حول مُجمل “التحقيب التاريخي” لوجود الإنسان، وحضاراته على الأرض، وذلك على اختلاف إسهامات كل أُمة من الأمم عبر العصور، ومن ثم اختلاف دورها، وكذلك تأثيرها الحضاري في التراث الإنساني. غير أن ذلك لم يمنع في ذات الوقت من ظهور بعض الرُؤى والفرضيات المتباينة تجاه ذلك “التحقيب” العام الذي قد يميل إليه أكثر المُتخصصين، والباحثين، وهو أمرٌ يتفق على أية حال مع طبيعة “علم التاريخ”History بصفةٍ خاصة، وكذا باقي “العلوم الإنسانية” Human Sciences بصفةٍ عامة[6]، إذ من المعلوم أن الحقيقة تبدو نسبية في دراسة العلوم الإنسانية، ولاتبدو فيها ما يُمكن أن يُقال له “الحقيقة المطلقة” على غرار العلوم الطبيعية.
ثانيًا- أثر الكوارث الطبيعية في التحقيب التاريخي حتى القرن 4م:
شهد تاريخُ الإنسان على الأرض، وبمرور الحقب المُتعاقبة العديد من الأحداث، أو بمعنى أدق “الكوارث الطبيعية” التي أصابت الأرض، وقاطنيها، ومن ثم أثرت بشكلٍ فاعل في حياة الإنسان، وغيرت من طرق معيشتهن ومن البيئة التي يسكن فيها، وقد اختلف تأثيرُ كلٍ منها حسب قوة الكارثة الطبيعية، وكذلك امتداد أثرها الجغرافي، والزمني. ومن أفضل ما قيل حول أثر “الكوارث الطبيعية” في حياة الإنسان، يقول البروفيسور “مانفريد كلاوس”: “تلعب الكوارثُ الطبيعية دورًا ذي خصوصية في خضم ذاكرة البشر..والانطباع المؤثر عن هذه الكوارث فيما مضى أكثر عُمقًا، حيث لم تكن هناك تفسيرات علمية في متناول اليد، بل كانت أية ظاهرة طبيعية تخرج عن مسارها الطبيعي، تُفسر على أنها هجوم من الآلهة..”[7]. ولعل هذا يُشير بشكلٍ واضح لطُغيان ما يُعرف بـ”التفسير الديني”، أو “اللاهوتي” (الكهنوتي)، لحدوث “الكوارث الطبيعية” في الماضي، وهو أمرٌ معروف لا يمكن إنكاره. وعلى أية حال كان لبعض الكوارث تأثيرٌ كبير على مُجريات الأحداث، ولعب بعضُها دورًا فيما يُعرف بـ”التحقيب التاريخي”، وكذلك “التحقيب الجيولوجي”[8] لاسيما إبان العصور الغابرة، وذلك من خلال تأثير “الكارثة الطبيعية” الفاعل على أي من الأمم أو الشعوب، وكذا مدى تأثيرها على الحضارات الأخرى التي كانت معاصرة لوقوعها. ومن المعلوم أن “التحقيب الجيولوجي” أقدم من زمنيًا من “التحقيب التاريخي”، لأن “التحقيب الأول” يرتبط بالأحداث الجيولوجية المبكرة من عمر الأرض، وتشكيلها الجيولوجي، وكان ذلك بالطبع منذ حقب زمنية بعيدة جدًا قبل أن يعيش الإنسان على هذه الأرض، أما “التحقيب التاريخي” فإنه مرتبطُ بالإنسان، وتاريخه، والأحداث التي قام بها.ويرى البعضُ أن “الظواهر الطبيعية” كالزلازل والبراكين، وكذلك السيول، والفيضانات..الخ، وغيرها إذا
[1] للمزيد عن مصطلح “حقبة” و”الحقب” في المعاجم اللغوية (مادة حقب)، انظر أبوبكر الرازي: مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1925م، ص146، وللمزيد انظر أيضا ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثالث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2014م، ص174.
[2] علم الفيلولوجيا: هو مصطلح غربي مشتق في الأصل من لفظي (فيلو– لوجو)، ويشير هذا المصطلح إلى ما يعرف بـ”علم اللغة”، أو ما يُعرف بـ”فقه اللُغة” (وللمزيد عن ذات المصطلح، ومودلولاته، انظر أحمد السعيدي: الفيلولوجيا..من فقه اللغة إلى تحقيقي التراث، مجلة الفيصل، عدد 4، سبتمبر 2018م).
[3] الرازي: مختار الصحاح، ص146.
[4] المصدر نفسه، ص146.
[5] ابن منظور: لسان العرب، جـ3، ص174.
[6] من المهم في هذا الصدد تعريف معنى كلمة أو مصطلح “التاريخ”، حيث يذكر البعضُ أنه يعني في رأي البعض اللغة: “الإعلام بالوقت وقال آخرون: “التاريخ تعريف الوقت والتوريخ، ويقال: أرخت، وورخت (انظر السخاوي: الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص6). وفي ذات الشأن يشير اللغوي العربي المعروف “الأصمعي” إلى دلالة ومفهوم لفظ التاريخ: “فقال بنو تميم: يقولون ورخت الكتاب توريخًا، وقيس تقول: أرخته تأريخًا..” (السخاوي: المصدر السابق، ص6).
[7] مانفريد كلاوس: الإسكندرية أعظم عواصم العالم القديم، ترجمة: أشرف نادي محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2009م، ص298-299.
[8] التحقيب الجيولوجي: يُقصد بهذا المصطلح تقسيم الحياة على الأرض عبر تاريخها الجيولوجي إلى مراحل، وما ارتبط بها من تغيرات جيويولجية وقعت، وساهمت في تغير شكل الأرض عبر التاريخ (وللمزيد عن ذلك، انظر ياسين صالح كريم: الجيولوجيا التاريخية، طبعة جامعة تكريت، د.ت، ص2-3).
خريط ة توضح كيف كانت قارة جندوانا القديمة قبل انفصال آسيا وأفريقيا
انظر كولين ماكيدي: أطلس التاريخ الأفريقي، ص16.
تسببت في وقوع ضحايا من البشر، فإنها بذلك قد تحولت من مجرد “ظاهرة طبيعية” إلى “كارثة” طبيعية وذلك بسبب تأثيرها المُدمر على الإنسان، وتهديدها لحياته. ولاريب أنه امتد تأثير بعض “الكوارث الطبيعية” فيما يُعرف بـ”التحقيب الجيولوجي” ذاته، وما يرتبط بـ”الحقب الجيولوجية” التي مرت بها الأرض خلال تكوينها المبكر عبر ملايين السنين[1]. وعلى أية حال فقد أثرت بعض “الأحداث الجيولوجية” في التحقيب الخاص بالأرض قبل وجود الإنسان، أي أننا نتحدث عن حقب زمنية بعيدة جدًا، ربما تبلغ عشرات الملايين من السنين الغابرة. ولعل من بين ذلك حدوث ما يُعرف بـ”الانشقاق الكبير” في “القارة الأم” القديمة المعروفة بقارة “جندوانة”، أو “جندوانا”. وهذا الانشقاق الجيولوجي القديم كان عبارة عن حدوث شق طبيعي في الأرض، وهو ما تسبب في انفصال قارتي آسيا وأفريقيا عن بعضهما البعض، ويقال إن ذلك الانشقاق كان قد وقع منذ قرابة أربعين مليون سنة. إذ كانت هاتان القارتان قبل ذلك الزمن تُشكلان كُتلةً واحدة، وقد أدى ذلك الانشقاق لظهور “البحر الأحمر”، حيث لم يكن يوجد سوى “البحر المتوسط” القديم، وهو المعروف باسم: “بحر تيثيس”[2]. أما هذا الانشقاق، وما نتج عنه من تداعيات، وامتداده جغرافيا صوب الشمال، وبلوغ تأثيره الجغرافي حتى بلاد الشام، وهو ما يُعرف بـ”الأُخدود الأفريقي” African Rift. وفي ذات الشأن يُشير بعضُ الدارسين المُحدثين لفكرة الربط بين انهيار بعض الحضارات من جانبٍ، ووقوع “الكوارث الطبيعية” الكبرى من جانب آخر، أو ما يُطلق عليه البعضُ “فقدان شعوب تلك الحضارات السيطرة على بيئتها المادية”[3].
ويرى الباحثُ أن فُقدان السيطرة على “البيئة المادية” يُشير بوضوحٍ لوقوع “الكوارث الطبيعية” التي قد تُصيب بعض الشعوب منذ القدم، وربما يكون بعضُ تلك “الكوارث” في حدتها خارجةً عن سيطرة الإنسان، لدرجة أنه لم يستطع التعامل معها. وكان من أبرز “الكوارث الطبيعية” التي حدثت خلال “الحقب الجيولوجية” القديمة تلك التي تسببت في اختفاء “الديناصورات” Dinosaurs[4] من على الأرض، ويُطلق البعضُ على ذلك “العصر العتيق” الذي اندثرت فيه “الديناصورات” تسمية عصر “المحنة والفناء”[5]. وتُصنف “الديناصورات” بأنها من مجموعة “الزواحف” القديمة التي عاشت على الأرض مدةً تقارب “140” مليون سنة[6]. وقد عاشت “الديناصورات” خلال العُصور الجيولوجية السحيقة، وتحديدًا منذ حقبة “العصر الترياسي” المتأخر Late Triassic Period، وحتى آواخر “العصر الكريتاسي”Cretaceus Period ، وكان يعيش على الأرض آنذاك فيما يقال أكثر من 800 نوعا منها[7]. وعلى أية حال فقد اندثرت “الديناصورات”، واختفت من على الأرض منذ قرابة 64 مليون سنة[8].
ولاريب أن ذلك وقع بسبب إحدى “الكوارث الطبيعية”، ويُرجح البعضُ سبب ذلك على وجه التحديد لوقوع بعض التغيرات والانقلابات المُناخية الهائلة التي أدت بدورها لإبادة أكثر الزواحف التي كانت تعيش على الأرض في ذلك الوقت، وكان من أبرزها “الديناصورات”[9]. بينما يذهب آخرون إلى أن اختفاء “الديناصورات” كان بسبب سقوط قذائف من السماء على الأرض، ويُقصد بها أنواعٌ من الشُهب والنيازك، وكانت فيما يقال هائلة الحجم، ومن ثم تسبب في حدوث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بسبب ارتطامها الشديد بالأرض، ثم احتراقها على أديم الأرض، وهو ما تسبب في هلاك “الديناصورات”[10]. ولاريب أن اختفاء “الديناصورات” يُعد من الأحداث الكبرى في تاريخ الحياة على الأرض، وهو ما يُعرف بـ”التحقيب الجيولوجي” قبل وجود الإنسان على الأرض بملايين السنين.
وفي ذات الشأن كان من الأحداث المُهمة إبان العصور القديمة، ربما منذ بضع آلاف من السنين قبل الميلاد ما يذكره البعضُ عن اندثار “قارة الأطلانتس” (ويكتب الاسم أيضًا: “أطلنتيس”) Atlantis[11]، ومن ثم اختفاء الشعب الذي سكن تلك البلاد، وكان يحمل ذات الاسم، وكذلك اندثار الحضارة التي أقامها هذا الشعب. وكان الكهنة المصريون بمعبد “سايس” بالدلتا هم أول من تحدثوا عن شعب “الأطلانتس”، ثم تحدث العالم الإغريقي “صولون” (سولون) Solon (ت: 560 ق.م) عن قصة اختفاء هذا الشعب الغامض، ويذكر “صولون” أنه سمع تلك القصة من الكهان المصريين خلال إقامته بمصر، ثم نقل “صولون” قصة هذا الشعب بعد ذلك إلى بلاد اليونان، ثم تحدث عن ذات القصة بعد “صولون” بحوالي قرنين الفيلسوف اليوناني “أفلاطون” Plato(ت: 347 ق.م)[12]. ويعتقد البعضُ أن شعب “الأطلانتيس” كان ذا مدنيةٍ مُتقدمة منذ أكثر من 3000 عام، أو أكثر، وكانوا يسكنون فيما يقال في منطقة ما تقع بـ”المحيط الأطلنطي”، ويشير البعضُ إلى أن هذا الشعب ربما عاش في منطقة ليست بعيدة عن مضيق “جبل طارق”، وحسب بعض الروايات التاريخية اشتهرت بلاد “الأطلانتس” بحدائقها المعروفة باسم: “حدائق هيسبرديس”[13]. بينما يصف البعضُ من جانب آخر حضارة “الأطلانتس” بأنها أقرب إلى “الأسطورة” أكثر من كونها قصة شعب حقيقي عاش على الأرض، وعلى هذا يُطلق البعضُ على تلك البلاد اسم: “القارة المفقودة”، أو “أطلانتس المفقودة”[14]. وعلى أية حال لاتزال قصة شعب “الأطلانتس”، وحضارته، يحيط بها من الغُموض حتى يومنا.
ومن جانبٍ آخر أدت أنماطٌ من “الكوارث الطبيعية”، لاسيما ما يرتبط بوقوع “الجفاف” و”المجاعات” وما شابه من الأحداث الطبيعية لهجرات بشرية واسعة من بعض المناطق إلى أقاليم أخرى أكثر استقرارًا، وهو ما ساهم في إحداث “تحقيب تاريخي” جديد، ولعل منها على سبيل المثال تلك التغيرات المناخية الشديدة التي وقعت في نطاق “الصحراء الكبرى” منذ آلاف السنين، وهو ما أدى لنزوح أعداد كبيرة من السكان[15]. ويُحدد البعض الحقبة التي حدثت فيها تلك الهجرات البشرية لما قبل القرن “العاشر” قبل الميلاد[16]. وأدت تلك الموجة من الجفاف، وربما المجاعات، لهجرات عددٍ من القبائل والبطون البربرية من شمال أفريقيا صوب الشرق وتحديدًا إلى أرض مصر، ثم استقرت تلك الجماعات في بعض الأقاليم غرب مصر. وقد برزت من بين تلك الجماعات “أسرة بربرية” خرج منها شخصٌ نال أهمية كبيرة في التاريخ، وهو الملك “ششنق الأول” Shoshenq (945-925 ق.م)[17]، ويكتب البعضُ اسمه: “شاشانق”[18]، وهو الذي ارتقي عرش مصر في حوالي منتصف القرن 10 ق.م، ومن ثم أسيس “أُسرةً ملكية” جديدة، ولكنها كانت من أصول “غير مصرية”، وهي الأسرة “الثانية والعشرون”. ويرى البعض أن الملك “ششنق الأول” كان في الأصل من قبائل “المشواش” البربرية، وقيل أيضًا إن أجداده الأوائل كانوا من قبائل “التحنو”[19]، ومن المعلوم أنهم من قبائل البربر القدامى، وكانوا من قاطني شمال أفريقيا في الأصل. وكان جد “ششنق” يُدعى بذات الاسم، وكان يلقب بـ”رئيس المشواش العظيم”[20]. ولعل هذا يُشير لوجود هجرات كبيرة من بطون “البربر” آنذاك، ولهذا فمن المُعتقد أن أعدادهم كانت كبيرة، وكان لهذه الجماعات رئيس يتولى أمرهم. وصار “ششنق الأول” قائدًا للجيش المصري خلال حكم الملك “بسوسنس”، ثم ارتقى “ششنق” عرش مصر من بعده، وجدير بالذكر أن البعض يُطلق على هذه الأسرة اسم “الأسرة الليبية”[21]. وعلى أية حال يُعتبر ذلك الحدث بداية مرحلة “تحقيب تاريخي” مُهمة في تاريخ مصر القديمة، وقد نتج ذلك التحقيب التاريخي الجديد بسبب التغيرات الطبيعية والمناخية التي حدثت في شمال أفريقيا، والتي أدت بدورها لهجرات بشرية من جانب جماعات من البربر صوب الغرب، ثم صار أحد هؤلاء من الأجيال اللاحقة ملكًا على مصر، وهو ما يؤكد ذات الفكرة التي تقوم على أن أحداث الطبيعة لها تأثير كبير في تاريخ الإنسان، وظهور تحقيبات تاريخية جديدة.
وكان من بين الأحداث الأخرى الغامضة إبان العصور القديمة التي وقعت بسبب “الكوارث الطبيعية”، ما تذكره بعض المصادر عن اختفاء جيش الملك الفارسي “قمبيز” (530-522 ق.م)، أو هلاك هذا الجيش في صحراء مصر الغربية حوالي سنة 525 ق.م، ومن الراجح أن ذلك كان بسبب هبوب رياحٍ عاتية على الجنود الفرس، ومن ثم أهلكتهم هذه الرياح[22]. ويُشير البعضُ إلى أن “قمبيز” لما استولى على مصر أراد أن يهدم “معبد أمون” في واحة سيوة المعروف بـ”معبد الوحي”، وكانت له شهرة واسعة في العالم القديم، لأنه علم أن كهنة أمون زعموا بأن مصيره سوف يكون الهلاك، ومن ثم أراد أن ينتقم منهم، وأن يثبت أن نبؤاتهم ليست حقيقية[23]. ثم أرسل “قمبيز” جيشًا كبيرًا من طيبة (الأقصر حاليا) غربًا عبر الصحراء، ثم وصل الجنود الفرس إلى “الواحات الخارجة” بعد 7 أيام منذ بدء مسيرهم، ثم اتجهوا بعد ذلك نحو طريق “واحة سيوة”، ويُعتقد أن هذا الجيش هلك كله قبل أن يصل “سيوة” بسبب العواصف والرياح الرملية الشديدة قادمةً من غرب الصحراء. وقد أهلكت هذه العواصف الجنود الفرس عن بكرتهم، ولم ينته الأمر عند ذلك، إذ إن الرياح من شدتها طمرت هؤلاء الجنود تحت الرمال، ولم يعد لهم أثر بعد ذلك[24]. ويذكر “هيرودوت” Herodotus(عاش حوالي سنة 445 ق.م) في روايته أن قوام الجيش الفارسي الذي هلك في الصحراء كان يبلغ حوالي 50 ألف جندي[25].
وعن هلاك تلك الحملة بواسطة إحدى “الكوارث الطبيعية”، يقول “هيرودوت”: “هناك على أية حال قصةٌ يحكيها الأمونيون (سكان واحة سيوة)، وغيرهم ممن سمعوا منهم، فحواها أنه بعد أن ترك الرجال (أي الجنود الفرس) الواحة، وبينما كانوا يتناولون طعام الغذاء، هبت ريح جنوبية بالغة العنف، فأهالت الرمال أكوامًا عليهم، وهكذا هلكوا إلى الأبد..”[26]. ويرى البعضُ أن سبب هلاك هذا الجيش، وخسائر قمبيز الأخرى جعلت ملك فارس يُصاب بالجنون، ويقال إنه مات منتحرًا بعد ذلك[27]. بينما يذكر “هيرودوت” أن “قمبيز” كان قد أُصيب بلوثة وجنون شديد بسبب هلال جيشه في الصحراء الكبرى، وأنه مات وهو في طريق العودة من مصر إلى بلاد فارس[28]، هكذا كان تأثير “الكوارث الطبيعية” في تاريخ الإنسان، وحدوث حركة تحقيب تاريخي جديدة، ولاسيما بعد تسببها في خروج الفرس من مصر.
ومن بين الأحداث الأُخرى التي كان للطبيعة وظواهرها تأثيرُ فيها أنه في حوالي سنة 224 ق.م وقع زلزالٌ عنيف في بعض المناطق بالبحر المتوسط، وتحديدًا بالقرب من “جزيرة رودس”Rhodes ، وهي واحدة من الجزر اليونانية[29]. وقد أدى هذا الزلزال إلى تهدم “عملاق رودس” Colossus of Rhodes المعروف الذي كان قد أقيم خلال الفترة (300-280 ق.م)[30]. وكان هذا التمثال الضخم أحد عجائب العالم القديم، وكان ارتفاعه حوالي 100 قدم، أو ما يعادل 30م[31]. وكان هذا التمثال الضخم يقف عند مدخل ميناء جزيرة “رودس”، وكان يصور “أبوللو” (أو هليوس)، وهو معبود الشمس عند الإغريق، وكان قد صممه فنانٌ يدعي “كاريس” Chares، وعلى أية حال لم يبق هذا التمثال سوى قرابة 50 سنة في موضعه، ثم سقط بعد ذلك بسبب هذا الزلزال[32]. وعلى هذا فقد صار هذا الأثر الذي كان من العجائب في زمانه أثرًا بعد عين بسبب إحدى “الكوارث الطبيعية” التي تسببت في تدميره.
وفي ذات الصدد وخلال حقبة القرن الميلادي الأول اختفت إحدى المدن الايطالية، واسمها “بومبي”Pombeii ، وكان ذلك الاختفاء المُفاجيء بسبب إحدى “الكوارث الطبيعية” والتي كانت نادرًا ما يكون لها تأثير في مجرى الأحداث التاريخية، ولعل ذلك بسبب قلة ما ورد عن تأثير هذه الظاهرة الطبيعية في ثنايا المصادر، وهي “البركان” Volcano. وتقع مدينة “بومبي” في مواجهة “خليج نابولي”Bay of Naples ، وكانت المدينة مكانًا للترفيه في تلك البلاد، غير أنه في أغسطس سنة 79م، نشط بركان “فيزوف“ Volcano Vesuvius القريب من تلك المدينة، وكان بركانًا خامدًا لمدة من الزمن، وفجاة نشط البركان، وكانت ثورته عنيفة، فألقى بـ”اللافا” على السكان القاطنين في المناطق القريبة له[33]. واستمر نشاط “بركان فيزوف” قرابة يومين، وكان نشاطه بمثابة كارثة لايمكن تصورها على سكان المناطق القريبة منه لاسيما مدينة بومبي، وهو ما أدى لاختفاء المدينة بالكامل بسبب تلك الكارثة[34]. وتم الكشف عن تلك المدينة المفقودة التي طواها النسيان سنة 1710م، ولما رفعت أنقاض البركان، وعوادم الزمن، ظهرت مدينة “بومبي” كما كانت في زمانها منذ حوالي 19 قرنًا مرت على اختفاء هذه المدينة تحت بقايا بركان “فيزوف”[35]. ولعل هذا الحدث المُهم يؤكد ذات الفكرة التي نطرحها، وهي أن “الكوارث الطبيعية” قد تكون حاسمة في حركة “التحقيب التاريخي”، وفي مسارها، لاسيما من خلال دور تلك الكوارث في اختفاء بعض المدن، أو الحضارات، أو حتى اندثار بعض الشعوب القديمة، وعلى هذا صارت “بومبي” في طي النسيان، وأضحت مدينة مفقودة مدة طويلة، حتى تم الكشف عنها منذ أقل من عقدين من الزمان.
ثالثًا-أثرُ الكوارث الطبيعية في التحقيب منذ القرن 4م حتى آواخر العصر الوسيط:
تنوعت أنماطُ “الكوارث الطبيعية”، وأشكالها، ومدى تأثيرها على النطاق الإقليمي الذي وقعت فيه خلال حقبة القرون الأولى للميلاد، وما بعدها حتى نهاية “العصر الوسيط”، أي حوالي القرن 15م. وقد تباينت أشكال تلك الكوارث ما بين الزلازل، والطواعين، والأوبئة، وكذلك وقوع الجفاف، والمجاعات، وكان لكل منها أسباب تختلف عن الأخرى. ومن أهم الأحداث خلال تلك المرحلة اختفاء الكثيرُ من معالم “حضارة كريت” القديمة بسبب أحد الزلازل الذي وقع إبان القرن الرابع الميلادي (حوالي سنة 65م)، وهو ذات الزلزال الشهير الذي تسبب أيضًا في اختفاء أجزاءٍ كبيرة من تُراث البحر المتوسط، وأدى لاندثار بعض المدن، أو أجزاءٍ منها[36]. ونظرا لشدة وقوة هذا الزلزال يصفه بعض المؤرخين بأنه “تسونامي كريت”[37]. كما يطلق عليه “مانفريد كلاوس” بأنه “تسونامي سنة 365م“، وعن ذلك يقول: “ويعتقد العلماءُ أن تسونامي عام 365م يرجع إلى زلزال مدمر للغاية بالقرب من شواطيء كريت، لدرجة أنه جعل قاع البحر يرتفع عند الشواطيء المصرية، ويتحول إلى أرض زادت عليها طبيعة الدلتا المتغيرة..”[38].
وفيما يعتقد أنه كان من أبرز تأثيرات هذا الزلزال أيضًا اختفاء أجزاء كبيرة من مدينة “الاسكندرية” القديمة تحت مياه البحر المتوسط، ويصف “مانفريد كلاوس” تأثير هذا الزلزال على مدينة الإسكندرية بأنه بمثابة “يوم الفزع” على سكان هذه المدينة العتيقة ذات التاريخ[39]. وكانت تلك المنطقة المعروفة بـ”حي هيراقليوم” من الأحياء القديمة بالإسكندرية، وقد عثرت عليه إحدى البعثات منذ نحو عقدين بقيادة عالم الآثار الفرنسي “جون إيف أُمبرور”[40]. وتم رفع بعض الآثار من قاع البحر، غير أنه بقيت أكثر الآثار مُتناثرةً في قاع البحر نظرًا لضخامة بعضها، وصعوبة رفعها. وحتى الآن لاتزال كتل منارة الإسكندرية التي سقطت أجزاءٌ كبيرة منها في البحر بسبب زلازل وقع بالإسكندرية في القرن 14م، ثم بنيت على أنقاضها “قلعة قايتباي”[41]. ويصف أحدُ المؤرخين القدامى ما وقع من تأثيراتٍ مُدمرةٍ بسبب هذا “التسونامي”: “إن الأمواج العاتية حطمت مدنًا كثيرة في فلسطين، وفي كل ليبيا، وكل مدن صقلية تحولت إلى حطام، كما حطمت الأمواج كل جزر اليونان ما عدا جزيرة نيكايا..”[42]. وهذا يؤكدُ أن الزلازل قد يكون لها تأثيرٌ كبير في الأحداث التاريخية، ومن ثم في حركة التحقيب في مناطق البحر المتوسط، وغيرها.
ومن جانبٍ آخر ضعُفت العديد من “الأُسرات الملكية” بسبب وقوع الأوبئة والطواعين خلال “العصر الوسيط”، وقد ارتبطت هذه الحقبة التاريخية بالكثير من الأحداث المهمة، لاسيما ما يرتبط بوقوع أنماط من “الكوارث الطبيعية” التي كانت قد ضربت العديد من شعوب العالم في ذلك الوقت. ويُعتبر المقريزي (ت: 845هـ) من أهم مؤرخي “العصر الوسيط” الذين تناولوا وقوع “الكوارث الطبيعية” في ذلك الوقت لاسيما في كتاب “إغاثة الأُمة بكشف الغُمة”[43]. حيث تحدث عن الأوبئة والطواعين التي ضربت مصر، وغيرها من بلاد العالم الإسلامي عبر التاريخ ابتداءً بـ”طاعون عمواس” الشهير الذي وقع سنة 18هـ، إبان خلافة “عمر بن الخطاب” (13-23هـ)، وتسبب هذا “الطاعون” الذي ضرب بلاد الشام في هلاك عدد ليس بالقليل من الصحابة رضي الله عنهم[44]. كما تحدث “المقريزي” بإفاضة عن الأوبئة والطواعين التي أصابت بلاد المسلمين لاسيما أيام المماليك (684-923هـ/1250-1517م)، ولعله يكون أفضل من تحدث في هذا الشأن، لأنه من أبرز مؤخي حقبة المماليك، وكان قريبًا من أحداثها، والكوارث الطبيعية التي أصابت الناسُ في ذلك الوقت، وكانت الأوبئة والطواعين العديدة التي أصابت المسلمين آنذاك قد أرهقت دولة المماليك، وكذلك البلاد التي كانت حكمهم[45]. ومن ثم فلم يكن من المُستغرب أن يُشير بعض المؤرخين المُحدثين إلى أن الأوبئة والطواعين كانت من أهم العوامل التي أدت لضعف دولة المماليك، ثم سقوط هذه الدولة في نهاية المطاف[46]. كما أن وقوع بعض “الكوارث الطبيعية” على غرار الطاعون، والجفاف، والقحط..الخ، كانت سببًا في إضعاف بعض السلاطين، ومن ثم انهيار حكمهم، ومن ذلك ما وقع أيام السلطان “العادل كتبغا” (694-696هـ)[47]. وحسب رواية المقريزي (ت: 845هـ) وقع في مصر وبعض بلاد المشرق الجفاف والمجاعات في حوالي سنة 695هـ، ومن ثم وقعت الأوبئة والأمراض بعد ذلك، وهو ما أدى لهلاك أعداد كبيرة من الناس[48]. بل إنه في ذات الرواية التي أوردها “المقريزي” يذكر أنه كان من أسباب الطاعون هبوب ريح جاءت من تخوم “برقة”، وأدت هذه الريح لهلاك الزرع، وفساده، وانتشرت بسببها الأمراض والأوبئة[49]. وعن هذا الطاعون، يقول “ابن كثير” (ت: 774هـ): “وفي مستهل هذه السنة (أي سنة 695هـ) كان الغلاء والفناء بديار مصر شديدا جدًا، وقد تفانى الناس إلا القليل..”[50]. وفي رواية، يصف “النويري” (ت: 733هـ) هذا الطاعون بـ”الفناء العظيم”[51] في إشارة لما تسبب فيه الطاعون في إفناء وهلاك أعداد هائلة من الناس.
ويرى البعضُ أن أشد الأزمات التي عاني منها سلاطين المماليك كانت تحدث بسبب انخفاض منسوب نهر النيل، وكانت الأمورُ الأمور سوءً إذا أصابت الناس صنوفٌ من الأوبئة والأمراض في ذات الآن[52]. بينما يذكر النويري: “واستهلت سنة خمس وتسعين وستمائة، في هذه السنة اشتد الغلاءُ بالديار المصرية، وكثر الوباء..”[53]. وربما يُفهم من هذه الرواية أنه وقعت المجاعة أولاً، ثم تبعها “الطاعون”، وهو ما يبدو واضحًا في أكثر الروايات، مثل المقريزي، وغيره. وعن وقوع الطاعون وما ارتبط به من الجوع والغلاء، يقول “ابن تغري بردي” (ت: 874هـ): “السنة الثانية من ولاية الملك العادل كتبغا على مصر، وهي سنة خمس وتسعين وستمائة، فيها كان الغلاء العظيم بسائر البلاد، ولاسيما مصر والشام، وكان بمصر مع الغلاء وباء عظيما أيضا، وقاسى الناس شدائد في هذه السنة..”[54]. ويذكر “المقريزي” أنه في سنة 695هـ وقع بالناس غلاءٌ شديد، واشتدت الأُمور على الناس، ورغم ذلك كانوا ينتظرون فرجًا قريبًا، وكان الناسُ يُمنون أنفسهم بمجيء موسم الغلال لتنضبط الأمور في بلادهم[55]. ولما أدرك الناسُ وقت الحصاد، وصاروا أقرب ما يكون منه، وقع البلاءُ[56].
وثمة رواياتٌ تشير إلى أن أصل هذا “الطاعون”، ومبدأه الأول، أنه هبت ريحٌ عاصفة قادمة من التُخوم الغربية، وكانت العاصفة تحمل ترابًا يميل للصُفرة، ثم غطت تلك الأتربة الهائلة الحقول والزراعات، مما تسبب في إفساد المزروعات والمحاصيل، وهو ما أدى لوقوع الجفاف والقحط الشديد بمصر. ولعل هذا يشير لشدة البلاء الذي وقع بالناس آنذاك، وأن الأمراض انتشرت بهم، وكان أبرزها ما يرتبطُ بمرض “الحُمى”، وهو المرضُ الذي يرتبط بشدة بـ”الطاعون” أكثر من غيره من الأمراض. ولعل إشارة المقريزي في هذا الصدد بأن المرض والحميات أصابت سائر الناس يبين بوضوح أن الأمراض والحمى كانت قد عمت كثيرين من الناس آنذاك. ثم تكمل “رواية المقريزي” تلك الصورة القاتمة، والمأساوية بعد أن وقع هذا الخطب، حيث اختفت من الأسواق الأدوية والأعشاب التي كان يحتاجها المرضى للتداوي من الأمراض التي أصابتهم، ومن ثم ارتفعت الأسعار ارتفاعات هائلة في ذلك الوقت[57]. ويرى الباحثُ أن تلك الريح التي تذكرها المصادر يُقصد بها في الغالب “رياح الخماسين” المعروفة[58]، وهي رياح تهب على أرض مصر منذ آواخر الشتاء، وبدايات الصيف، وتأتي هذه الرياح من المناطق الصحراوية في الغرب[59]. ومن المعلوم أن رياح “الخماسين” هي نوعٌ من الريح الموسمية الشديدة، والتي تتسم بسمات خاصة بها، حيث إنها رياح مُثيرة للرمال والأتربة، وفي الغالب يصحب هذه الرياح انتشار بعض الأمراض، مثل: “الحصبة”، و”الأنفلونزا”، وأمراض العيون[60]. وكانت كل هذه الأحداث والكوارث الطبيعية العديد التي أصابت مصر، وغيرها من بلاد المشرق الإسلامي أيام السلطان كتبغا أدت لوجود قناعة لدى الشعب بأن حكم هذا السلطان نذير شؤم على الناس، وأنه لابد من الخلاص منه[61]. كل تلك الأمور تؤكد فكرة الارتباط الوثيق بين “الكوارث الطبيعية” و”التحقيب التاريخي”، ولاسيما كون تلك الكوارث عاملاً مؤثرًا في إضعاف بعض الدول والإمبراطوريات عبر التاريخ، وكذا دورها في انهيار حُكم أحد الملوك.
رابعًا- الإنسانُ وقُدرتهُ على التَكيُف مع بعض الكوارث الطبيعية:
نُورد في هذا المبحث جانبًا من قدرة الإنسان والتي ربما يكون من الإنصاف أن ننعتها بأنها كانت محدودة للغاية في التعامل مع بعض نماذج الظواهر الطبيعية التي وقعت عبر التاريخ، ومحاولة احتوائها، لاسيما خلال “العصر الوسيط”، ولعل من أبرزها “الرياح الموسمية” Seasonal Winds، وهي نوعٌ من الرياح العاتية تهب على المحيط الهندي، أو بحر الهند حسب مصادر العصر الوسيط[62]. ولعل قدرة الإنسان في ذلك الوقت على التعامل مع تلك الظاهرة الطبيعية هو ما أدخلها في إطار الظواهر وليس الكوارث، لكنها كانت في وقت ما تُشكل أحد أنماط “الكوارث الطبيعية” على التُجار والبحارة. وكانت هذه الرياح تهبُ مرتين في العام، مرة صوب سواحل شرق أفريقيا، والأخرى قادمة من الغرب في إتجاه جنوب شرق آسيا، وجزر المحيط الهندي[63]. وأدت هذه “الرياح” لهلاك أعداد كبيرة من السفن، بمن كان عليها من البحارة، والتُجار، وغيرهم من صُنوف المسافرين[64]. ورغم ذلك إلا أن التُجار والبحارة الذين كانوا يقومون بالرحلات التجارية عبر المحيط حاولوا قدر إستطاعتهم التكيف مع تلك الظاهرة، وأخذوا يحسبون وقت هبوب الرياح في كل إتجاه، ومدى قوتها، ومن ثم بدأوا يستغلون هبوبها في رحلاتهم سواء في اتجاه سواحل شرق أفريقيا، أم في الاتجاه الآخر صوب جنوب شرق آسيا[65].
ومن اللافت أن تلك الرياحُ لعبت دوراً في التواصل التجاري بين سواحل شرق أفريقيا، والتي يُقصد بها سواحل “بلاد الزنج” في المصادر الوسيطة[66] من ناحية، والأسواق في مناطق جنوب شرق آسيا من ناحية أخرى، هذا رغم الصعوبات والمخاطر التي كانت تُشكلها هذه الرياح الموسمية، إلا أن سكان هذه البلاد تعلموا من خلال تجاربهم العديدة عبر السنين الطوال في الإبحار بين أمواج “المحيط الهندي” الهادرة خلال أكثر أوقاتها، وأنهم أدركوا كيفية الاستفادة من هبوب هذه الرياح، وأن يُطوعوها لخدمة تجارتهم، لاسيما وأن “التجارة” عبر “المحيط الهندي” لسكان هذه البلاد تُعد المورد الاقتصادي الذي لا غنى عنه بالنسبة لهم، وكان ذلك التعامل مع الرياح بحيث لاتُسبب لهم عائقاً للتواصل بين المواني والمرافيء الواقعة في أقصى الشرق من جانب، وأندادها الواقعة في أقصى الغرب من جانب آخر[67]. ومن المعلوم أنه تُطل على هذا البحر (أي المحيط الهندي) سواحل العديد من البلدان، ومنها: الصين، وبلاد الهند، والسند[68]، وكذا عُمان، وعدن، وبلاد الزنج..وغيرها[69]. ويُوصف “المحيط الهندي” بأنه بحر ذو أمواج عظيمة، وكأنها “الجبال الشواهق”، كما توصف الأمواج في هذا البحر بأنها “أمواجٌ عمياء”، ويُقصد بذلك أن البحارةُ كانوا إذا توسطوا “بحر الهند”، ودخلوا بين أمواجه، فإن هذه الأمواج كانت تبدو عاتيةً، وكانت قوية الحركة، وشديدة الاندفاع، وكانوا لا يرون ما حولهم، كما كان الموجُ في داخل المحيط الهندي يرتفع بشكلٍ مُفاجيء أمام السفن التجارية مثل ارتفاع الجبال السامقة، ثم كان هذا الموجُ ينخفضُ مرة أخرى كأدنى ما يكون من “الأودية”، ومع ذلك لم تكن تنكسر أمواج هذا البحر، ثم يُضيف المسعودي في وصفه: “ولا يظهر من ذلك الَزبَد…”[70]. ولعل هذا يؤكد خطورة أمواج “المحيط الهندي”، وحدتها في ذلك الوقت، ولاريب أنه كانت تزداد خطورة الإبحار داخل مياه هذا المحيط لاسيما مع هبوب هذه الرياح الموسمية آنفة الذكر، وعلى هذا كان على البحارة أن يتعاملوا مع هذه الرياح بأية وسيلة.
وتذكر المصادر التاريخية أن البحارة في هذه البلاد كانوا يعرفون آوان هذه الرياح، ووقت هبوبها بحكم التجربة، والعادة، وأنهم كانوا يتوارثون معرفة ذلـك فيما بينهم، ولهم في هذه المعارف بأوقات “الرياح الموسمية” علاماتٌ وإشاراتٌ كانوا يعملون بها إبان[71]. وقد كانت الرحلة تستغرق فيما بين سواحل “البحر الأحمر” وسواحل الهند حوالي 6 شهور، وربما أقل من ذلك[72]. بينما يقال إن الرحلة من بلاد الصين إلى سواحل وموانيء عُمان ذهاباً وإياباً كانت تستغرق قرابة العام[73]. ويذكر المسعودي في روايته: “ولكل من يركب هذه البحار من الناس يعرفونهـا في أوقاتٍ تكون منها مهابّها قد عُلم ذلك بالعادات، وطول التجارب، يتوارثون علم ذلك قولاً، وعملاً، ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها إبان هيجانه، وأحوال ركوده، وثوراته. هذا فيما سمينا من “البحر الحبشي” والروم والمُسافرون في البحر الرومي سبيلهم، وكذلك من يركب بحر الخزر الى بلاد جرجان، وطبرستان، والديلم..”[74]. وقد أفاضت المصادر التاريخية في وصف “المحيط الهندي” حيث تذكر أنه يمتد امتداداً واسعاً من الغرب إلى الشرق، وتحديداً من أقصى “بلاد الحبش” (شرق أفريقيا)، أو بلاد الزنج، لأقصى تخوم الصين والهند[75]. ويُطلق مؤرخو العصر الوسيط على “المحيط الهندي” اسم “البحر الهندي”، كما يُعرف بـ”البحر الأخضر”، و”البحر الكبير”، و”البحر المحيط”[76]. وكان التُجار العُمانيون بصفةٍ خاصة أكثر من غيرهم خبرةً بهذا البحر، وبأسراره، وكانوا أعرف أهل هذا الزمان بالتجارة في مياهه، وكانوا يعلمون أحوال الرياح، وأسرارها، وأوقات هبوبها، ومن ثم كانوا أكثر الناس درايةً بالأوقات التي يُؤثَرُ الإبحار خلالها سواء شرقاً، أي في إتجاه الصين، أم غرباً في إتجاه سواحل شرق أفريقيا[77].
وعلى هذا فقد أدرك التجارُ والبحارة العرب، وكذلك تجار بلاد جنوب شرق آسيا أسرار “الرياح الموسمية”، وأنها كانت تهب مرتين في السنة، وهو ما مكنهم من استغلال تلك الظاهرة، والقيام برحلتين من شرق آسيا صوب سواحل شرق أفريقيا. وكانت “الرحلة الأولى” تتم في موسم “الخريف” وهي المعروفة بـ”رحلة الشتاء”، حيث كانت الرياح تدفعُ السفن في اتجاه جنوب غرب إلى ساحل شرق أفريقيا[78]. بينما في موسم الربيع (رحلة الصيف)، كانت الرياح تهبُ على سواحل المحيط الهندي، ومن ثم كانت الرياح تدفع السفن إلى شمال شرق، وبذلك كانت السفن قرب ساحل شرق أفريقيا تتمكن من العودة لقواعدها مرة أخرى إلى الساحل الأسيوي[79]. وعلى أية حال فيُمكن القولُ بأن “الرياح الموسمية” شكلت ما يُمكن أن يكون سراً من الأسرار التي احتفظ بها البحارة والتجار العرب أكثر من غيرهم من أندادهم، وهو ما جعلهم قادرين على السيطرة على محطات التجارة البحرية عبر سواحل المحيط الهندي[80].
الخاتمة:
وبعد هذه “الإطلالة” عبر مراحل وحقب تاريخية عديدة من عمر الإنسان على هذه الأرض، وما وقع فيها من أنماط عديدة من الكوارث الطبيعية أثرت بشكلٍ لاجدال في حركة “التحقيب التاريخي”، يمكننا الخروج ببعض الاستنتاجات المهمة، ولعل منها:
– أشارت هذه الدراسةُ إلى أن الظواهر الطبيعية إذا تسببت في حدوث تدمير ووقوع ضحايا من البشر، فإنها تتحول من كونها ظاهرة طبيعية إلى ما يُعرف بـ”الكارثة الطبيعية”.
-أكدت الدراسةُ وجود نوعين رئيسيين من التحقيب التاريخي، وهما “التحقيب المحلي” الذي يرتبط بتاريخ أمة من الأمم، أو إقليم من الأقاليم، والثاني: “التحقيب العالمي”، أو التحقيب العام الذي يراد به وضع “تحقيب تاريخي” عام يجمع أكثر الشعوب مع بعضها في ذات الآن.
– كما أشارت هذه الدراسة إلى أن “الكوارث الطبيعية” كان لها تأثير واضح في الحياة على الأرض وحتى قبل ظهور الإنسان، وخلال ما يُعرف بـ”التحقيب الجيولوجي”.
– بينت الدراسةُ أنه مع ظهور الإنسان برز دور “الكوارث الطبيعية” مثل: الزلازل، والبراكين، والفيضانات، والجفاف، والمجاعات، والأوبئة، والطواعين..وغيرها، وكان لها تأثير واضح في العديد من المراحل والحقب التاريخية. وتتنوع تلك الظواهر حسب طبيعتها، وحسب أسبابها، وكذلك حسب ما ينتج عنها من نتائج، سواء كان ذلك في ذات الآن الذي تقع فيه “الكارثة الطبيعية”، أم تكون بعض النتائج متأخرة زمنيًا عن وقوع تلك الكارثة.
– أكدت الدراسة أن الإنسان تمكن أحيانًا من التكيف مع بعض الظواهر، ورغم أنها قد تحدث بعض الضحايا، لكن بسبب وجودها بشكل موسمي، وديمومتها في حياته، تمكن من التكيف معها، وتطويعها لصالحه، ومن أبرز تلك النماذج “الرياح الموسمية” التي كانت تهب على سواحل المحيط الهندي (أو بحر الهند). وعلى هذا حاول الإنسان التكيف بشكلٍ أو بآخر مع بعض أنماط “الكوارث الطبيعية” لاسيما في هذه الحالة (أي الرياح الموسمية)، ولاريب أن تعامل الإنسان مع هذه الرياح العاتية يشير لقدرته أحيانًا، وإن لم تكن في كل الظروف، على استغلال بعض “الظواهر الطبيعية” رغم قسوتها، وحدتها.
المصادر والمراجع
أولا- المصادر العربية:
1- ابن الأثير: أُسد الغابة (المختصر)، اختصار: محمد إبراهيم عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2018م.
2- ابن البلخي: فارس نامة، تحقيق: يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1999م.
3- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ8، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2008م
4- ابن حوقل: صورة الأرض، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، طـ1، 2009م.
5- ديودور الصقلي: ديودور الصقلي في مصر، ترجمة من اليونانية: وهيب كامل، دار المعارف، القاهرة، 2013م.
6- الرازي: مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1925م.
7-السخاوي: الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2018م.
8-ابن سعيد: كتاب الجغرافية، تحقيق: إسماعيل المغربـي، سلسلة ذخائر التراث العربـي، منشورات المكتب التجاري للطبـاعة والنشر، بيروت، 1970م.
9- الطبري: تاريخ الطبري، جـ1، اختصار: على الجندي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2014م.
10- العُمري: مسالك الأبصار، جـ1، اختصار: الدكتور عامر النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012م.
11- ابن كثير: البداية والنهاية، جـ13، تحقيق: الدكتر أحمد أبوملحم (وآخرين)، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
12- المسعودي: مروج الذهب، جـ1، تحقيق: مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت.
13- المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999م.
14- ابن منظور: لسان العرب، جـ3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2014م.
15- النويري: نهاية الأرب، جـ31، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992م.
16- هيرودوت: هيرودوت يتحدث عن مصر، ترجمة: محمد صقر خفاجة، دارالقلم، 1966م.
ثانيا- المراجع العربية والمعربة:
17– أحمد السعيدي:الفيلولوجيا من فقه اللغة إلى تحقيق التراث،مجلة الفيصل، عدد4، 2018م.
18– أحمد فخري: واحات مصر، جـ1 (واحة سيوة)، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 1989م.
19– أرنولد توبنبي: مختصر دراسة للتاريخ، جت1، ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: شفيق محمد غربال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2015م.
20– جراية محمد رشدي: الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة منتورة (قسنطينة)، الجزائر، 2008م.
21– جي. إتش. ويلز: معالم تاريخ الإنسانية، جـ1، ترجمة: عبدالعزيز توفيق جاويد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2018م.
22– جان إيف أمبرور (وآخرين): الإسكندرية ملكة الحضارات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2007م.
23– جوردون تشايلد: ماذا حدث في التاريخ، ترجمة: جورج حداد، تقديم: حسين مؤنس، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2018م.
24– رولاند أوليفر: موجر تاريخ إفريقية، ترجمة: دولت أحمد صادق، سلسلة دراسات إفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1965م.
25– ريتشارد هول: امبراطورية الرياح الموسمية، ترجمة: كامل يوسف حسين، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،1990م.
26– ستانلي لينبول: سيرة القاهرة، ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997م.
27– سعيد عبدالفتاح عاشور: مصر في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك، مصر عبر العصور (تاريخ مصر الإسلامية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993م.
28– شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990م.
29– سليمان عبدالغني المالكي: دور العرب وتأثيرهم في شرق أفريقيا، ندوة العرب في أفريقيا الجذور التاريخية والـواقع المعاصر، كلية الآداب، جامعة القـاهرة، دار الثقـافة العربية، 1987م.
30– عطية القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت.
31– ف. هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، جـ2، ترجمة: أحمد رضا محمد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1991م.
32– كرم الصاوي باز: التبادل التجاري بين شرق أفريقيا وآسيا كما يصورها البلدانيون العرب في الفترة من (656–904هـ/1258–1498م)، ندوة مؤتمر التعاون العربي الأفريقي، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2007م.
33– ليونارد كوتريل (وآخرون): الموسوعة الأثرية العالمية، ترجمة: محمد عبدالقادر محمد، وزكي إسكندر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طـ2، 1997م.
34– مانفريد كلاوس: الإسكندرية أعظم عواصم العالم القديم، ترجمة: أشرف نادي محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2009م.
35– الموسوعة الثقافية، دار المعرفة (بالتعاون مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر)، مطابع دار الشعب، القاهرة، 1972م.
36– ول ديورانت: قصة الحضارة، المجلد الأول (1/2)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001م.
ثالثًا- المواقع الإليكترونية:
رابعًا- المراجع الأجنبية:
38– Basil Davidson: The African Past Chronicles, Penguin African Library, London, 1966.
39– Lynne Sable & Philip Steele: 1000 Great Events, Hamlyn Publishing Group, London, 1977.
40– Oliver D. Smith: The Atlantis Story an Authentic Oral Tradition, Shima Journal, Vol. 10. No. 2, 2016.
41– Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt, Thames & Hudson World of Art, London, 2005.
42– The Cambridge Paperback Encyclopedia, Edited by: David Crystal, Cambridge University Press, 2000.
43– Tom Gravey: Plato’s Atlantis Story, Aprose Hymn to Athena, Greek, Roman & Byzantine Studies, No. 48, 2008.
44– Vera Werner: Traces of the Late Bronze Age Santorini and AD 365 Tsunami events in the sedimentary record of crete, , Reconstruction of the regional Tectonic geomorphology mainz university, X111, 145 Blatter, 2019. 45– Yousrya Abdel-Aziz Hosni: Le Guide Historique et Archeologique d’Alexandrie, Le Conseil Supreme des Antiquites, le Caire, 2009.
[1] ياسين صالح كريم: الجيولوجية التاريخية، ص3.
[2][2] بحر تيثيس: هو الاسم القديم للبحر المتوسط منذ أقدم العصور الجيولوجية، وقبل ظهور البحر الأحمر. واسم تيثيس يوناني الأصل، وهو في الغالب يقصد بها إحدى المعبودات اليونانية القديمة، وهي التي تذكرها بعض المصادر اليونانية باسم: “الأم تيثيس”، يقول المؤرخ اليوناني المعروف “ديودور الصقلي” (وهو الذي عاش خلال القرن الأول الميلادي): “أوقيانوس مصدر الآلهة مع الأم تيثيس، ذلك لأن المصريين يعتقدون أن أوقيانوس هو نهر النيل عندهم، وأن الآلهة نشأت على حافتيه، ومصر هي البلد الوحيد في العالم كله الذي توجد فيه مدن كثيرة أنشأها الآلهة القدماء..” (انظر، ديودور: ديودور الصقلي في مصر، ترجمة من اليونانية: وهيب كامل، دار المعارف، القاهرة، 2013م، ص35.
[3]أرنولد توبنبي: مختصر دراسة للتاريخ، جت1، ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: شفيق محمد غربال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2015م، ص428.
[4] الديناصورات: للمزيد عن الديناصورات، وأصلها، وخصائصها، انظر جي. إتش. ويلز: معالم تاريخ الإنسانية، جـ1، ترجمة: عبدالعزيز توفيق جاويد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2018م، ص49-47.
[5] ويلز: معالم تاريخ البشرية، جـ1، ص49.
[6] The Cambridge Paperback Encyclopedia, Edited by: David Crystal, Cambridge University Press, 2000, P. 253.
[7] Ibid, P. 25
[8] Ibid, P. 253.
[9] ويلز: معالم تاريخ البشرية، جـ1، ص51.
[10] المرجع نفسه، ص51.
[11] للمزيد عن شعب الأطلنتس (أطلانطيس)، واصله، انظر ويلز: معالم تاريخ الإنسانية، ص178-179.
[12] Oliver D. Smith: The Atlantis Story an Authentic Oral Tradition, Shima Journal, Vol. 10. No. 2, 2016, PP. 8-9.
Tom Gravey: Plato’s Atlantis Story, Aprose Hymn to Athena, Greek, Roman & Byzantine Studies, No. 48, 2008, P. 382.
[13] ويلز: معالم تاريخ الإنسانية، ص178. ومن الواضح أن اسم هسبرديس يغلب عليه الأصل اليوناني، ويتضح فيه لفظ براديس (أو برديس) التي تعني الجنة في أكثر اللغات الأوروبية.
[14] المرجع نفسه، ص178.
[15] ترجع التغيرات المناخية التي حدثت في نطاق “الصحراء الكبرى” لحقب عديدة لما قبل القرن 10 ق.م، وكذلك خلال القرن 7 ق.م وكذلك بعده، وقد أدت بدورها للعديد من الهجرات البشرية من هذه المنطقة، وللمزيد عن ذلك الأمر تفصيلاً، انظر رولاند أوليفر: موجر تاريخ إفريقية، ترجمة: دولت أحمد صادق، سلسلة دراسات إفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1965م، ص26، وانظر أيضًا جراية محمد رشدي: الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة منتورة (قسنطينة)، الجزائر، 2008م، ص30.
[16] Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt, Thames & Hudson World of Art, London, 2005, P. 228.
[17] ششنق: ملكٌ من أصولٍ بربرية، وتحديدًا من قبائل “الماشواش” القديمة فيما يقال، وتذكر إحدى اللوحات الأثرية التي أقامها أحد الكهنة في أهناسيا بصعيد مصر الأوسط، ثم وضعت في “السيرابيوم” أن “ششنق الأول” كان من أسرة ليبية استقرت وقتا ما في احدى الواحات بصحراء مصر الغربية، ويرجح البعض أنها الواحات البحرية. ثم رحلت هذه الأسرة إلى أهناسيا، واستقرت بها منذ ستة أجيال، وهي تنحدر في الأصل لشخص اسمه: “بوبو– واوا”، وقيل: كان اسمه: “بيواوا” Buyuwawa (فيما يذكر برستد) وكان معاصرًا لآواخر “عصر الرعامسة” (الأسرة العشرين)، وكانت هذه “العائلة البربرية” قد بدأت تمصرها في منطقة الواحات، وتأثروا بالعقائد المصرية آنذاك، ولهذا صار موسن بن بوبوواوا كاهنا لمعبود أهناسيا (حري شف)، ثم زاد ثراء هذه الأسرة، وزاد نفوذها بمرور الوقت. ثم صار ابنه ششنق رئيس الحامية الليبية في المنطقة، وجمع في يده السلطتين الدينية والحربية، ثم خلفه ابن نمرودن ثم جاء ششنق المعروف الذي كان طموحا، ومد نفوذه في الدلتان وجعل تل بسطة مركزا له، وصار قائدا للجيش. ولم يقم ششنق بثورة ضد الملك بسوسنس، بل انتظر حتى مات الملك، وأحسن الملك ششنق الأول لعائلة الملك السابق، كما أنه زوج ابنه أوسركون من ابنة الملك السابق “بسوسنس” (للمزيد، انظر جـ. ه. برستد: فجر الضمير، ص356-357، انظر كذلك أحمد فخري: مصر الفرعونية، ص416-417).
[18] أحمد فخري: مصر الفرعونية، ص417.
[19] وللمزيد عن أجداد “ششنق الأول، انظر برستد: فجر الضمير، ص356. ويرى برستد أن هذه الأسرة ذات الأصل البربري صار لها نفوذ كبير في الدلتا أيام الأسرة 21، وكانت لهم كلمة مسموعة مع ملوك هذه الأسرة. وعن ارتقاء ششنق العرش، يقول برستد: “وفي عام 945 ق.م تمكن رئيس هذه الأسرة من الاستيلاء على عرش مصر، والتربع فيه بمدينة تل بسطة شرق الدلتا. ويعتبر هذا التغير الملكي إما نتيجة ضعف آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين، وإما نتيجة وفاته، وانقراض ذريته..” (برستد: فجر الضمير، ص356).
[20] جـ. ه.برستد: المرجع السابق، ص356.
[21] Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt, P. 228.
[22] وللمزيد عن الملك قمبيز، انظر ول ديورانت: قصة الحضارة، المجلد الأول (1/2)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص405. وانظر أيضا عن هذه الحملة، أحمد فخري: واحات مصر، جـ1 (واحة سيوة)، الهيئة المصرة العامة للكتاب، القاهرة، ص110.
[23] أحمد فخري: مصر الفرعونية، ص459.
[24] المرجع نفسه، ص459.
[25] أحمد فخري: واحات مصر، ص110.
[26] هيرودوت يتحدث عن مصر: ص55، وانظر أيضا أحمد فخري: واحات مصر، ص110.
[27] ول ديورانت: قصة الحضارة، المجلد الأول (1/2)، ص406.
[28] هيرودت يتحدث عن مصر: ص55.
[29] Lynne Sable & Philip Steele: 1000 Great Events, Hamlyn Publishing Group, London, 1977, P. 33.
[30] Ibid, P. 33.
[31] ليونارد كوتريل (وآخرون): الموسوعة الأثرية العالمية، ترجمة: محمد عبدالقادر محمد، وزكي اسكندر، مراجعة: عبدالمنعم أبوبكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طـ2، 1997م، ص293.
[32] Lynne Sable & Philip Steele: 1000 Great Events, PP.33.
[33] Ibid, P. 51-52.
[34] Ibid, P. 51.
[35] Ibid, P. 51.
[36] Vera Verner: Traces of the Late Bronze Age Santorini and AD 365 Tsunami events in the Sedimentary Record of Crete, Reconstruction of the regional Tectonic geomorphology, Mainz, 2019, P.1-2.
[37] Ibid, P.1-2.
[38] مانفريد كلاوس: الإسكندرية أعظم عواصم العالم القديم، ص300.
[39] المرجع نفسه، ص298.
[40] وعن إعادة اكتشاف تراث الإسكندرية القديم، انظر جان إيف أمبرور (وآخرين): الإسكندرية ملكة الحضارات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2007م، ص183. وللمزيد عن ذات الأمر، انظر مانفريد كلاوس: الإسكندرية، ص302.
[41] جان إيف أمبرور: الإسكندرية ملكة الحضارات، ص195. وكان هذا الزلزال قد وقع في سنة 1302م، وتسبب في سقوط جزء كبير من منارة الإسكندرية، وللمزيد عن ذلك، انظر:
Yousrya Abdel-Aziz Hosni: Le Guide Historique et Archeologique d’Alexandrie, Le Conseil Supreme des Antiquites, le Caire, 2009, PP. 26-27.
[42] مانفريد كلاوس: الإسكندرية، ص301.
[43] المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999م، ص63-64.
[44] طاعون عمواس: طاعون وقع بالشام في خلافة عمر بن الخطاب، وتسبب في موت عدد من الصحابة (تاريخ الطبري، جـ1، اختصار: على الجندي، هيئة الكتاب، القاهرة، 2014م، ص72، وانظر أيضًا ابن الأثير: أُسد الغابة (المختصر)، اختصار: محمد إبراهيم عوض، هيئة الكتاب، القاهرة، 2018م).
[45] المقريزي: إغاثة الأمة، ص63-64.
[46] ستانلي لينبول: سيرة القاهرة، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997م، ص183.
[47] المرجع نفسه، ص183.
[48] المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة، ص64.
[49] المصدر نفسه، ص64.
[50] ابن كثير: البداية والنهاية، جـ13، تحقيق: أحمد أبوملحم، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ص363.
[51] النويري: نهاية الأرب، جـ31، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992م، ص293.
[52] سعيد عبدالفتاح عاشور: مصر في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك، مصر عبر العصور (تاريخ مصر الإسلامية)، تاريخ المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993م، ص437. وعن أهم أسباب الأزمات أيام المماليك، يقول سعيد عبدالفتاح عاشور: “وعلى الرغم من المتاعب والأزمات التي تعرض لها الناس أحيانا في عصر سلاطين المماليك بسبب انخفاض النيل، وانتشار الأوبئة، أو بسبب الفتن بين طوائف المماليك، أو عسف بعض الحكام..” (مصر في عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك، ص437).
[53] النويري: نهاية الأرب، جـ31، ص293.
[54] ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ8، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2008م، ص78-79.
[55] النويري: جـ31، ص293.
[56] وعن ذلك الذي حدث، يذكر المقريزي: “وكان قرب أوانها، فعند إدراك الغلال، هبت ريحٌ سوداء مُظلمة، من نحو بلاد برقة هبوبًا عاصفًا، وحملت ترابا أصفر كسا زُروع البلاد، فهافت كُلُها (أي ذبلت)، ولم يكن بها إذ ذاك إلا زرع قليل، ففسدت بأجمعها، وعمت تلك الريح والتراب إقليم البحيرة، وإقليم الشرقية، ومرت إلى الصعيد الأعلى، فهاف الزرع، وفسد الصيفي من الزرع، كالأرز، والسمسم، والقلقاس، وقصب السكر، وسائر ما يزرع على السواقي، فتزايدت الأسعار..” (المقريزي: إغاثة الأمة، ص63).
[57] ولعل من هذه السلع المهمة: العسل والسكر، كما انعدمت الفواكه، وصار سعر الفروج بثلاثين درهما، وبيعت البطيخة الواحدة بأربعين درهما، وكان الرطل من البطيخ يباع بدرهم واحد، وأضحى سعر السفرجل الثلاث حبات بدرهم، وكان سعر البيض كل ثلاث منها بدرهم، ومن ثم ارتفعت الأسعار إرتفاعات حادة بما لم يعتاده الناس في ذلك الوقت. كما يقول المقريزي: “وتزايد القمح إلى إلى مائة وتسعين الأردب، والشعير إلى مائة وعشرين، والفول والعدس إلى مائة وعشر دراهم الأردب..” (إغاثة الأمة، ص63).
[58] رياح الخماسين: رياح جنوبية حارة، يتكرر هبوبها بتولد أو غزو الانخفاضات الجوية الصحراوية لمصر منذ آواخر الشتاء وبدايات الصيف، وهذه الرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة، ثم يصفو الجو بعدها لدى دخول الهواء البارد نسبيا قادما من البحر المتوسط، وربما يمتد تأثير هذه الرياح حتى أوروبا. وخلال هبوب رياح الخماسين تكثر الحرائق في القرى والريف المصري بسبب التغيرات الفجائية في اتجاه هذه الرياح، وسرعتها، ومن المعلوم انه يرافق هبوب هذه الرياح انتشار بعض الأمراض. ويعني مصطلح الخماسين أي الخمسون يوما التالية لعيد شم النسيم (الموسوعة الثقافية، دار المعرفة (بالتعاون مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر)، مطابع دار الشعب، القاهرة، 1972م، ص429).
[59] الموسوعة الثقافية: المرجع السابق، 429.
[60] المرجع نفسه، ص429.
[61] ستانلي لينبول: سيرة القاهرة، ص183.
[62] المسعودي: مروج الذهب، جـ1، تحقيق: مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص88.
[63] وللمزيد عن “الرياح الموسمية”، انظر المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص88، جوردون تشايلد: ماذا حدث في التاريخ، ترجمة: جورج حداد، تقديم: حسين مؤنس، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2018م، ص273-274، ف. هايد: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، جـ2، ترجمة: أحمد رضا محمد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1991م، ص81-84. وانظر ريتشارد هول: امبراطورية الرياح الموسمية، ترجمة: كامل يوسف حسين، مركزالامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،1990م، شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990م، ص262.
[64] المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص84.
[65] سليمان عبدالغني المالكي: دور العرب وتأثيرهم في شرق أفريقيا، ندوة مؤتمر العرب في أفريقيا الجذور التاريخية والـواقع المعاصر، كلية الآداب، جامعة القـاهرة، دار الثقـافة العربية، 1987م، ص123.
[66] بلاد الزنج: يقصد بها البلاد التي تقع على ساحل شرق أفريقيا، وتمتد من مقدشو شمالاً وحتى ميناء سفالة (موزمبيق حاليا) جنوبًا (مروج الذهب، جـ1، ص84، هول: الرياح الموسمية، ص59. وانظر:
Basil Davidson: The African Past Chronicles, Penguin African Library, London, 1966, PP. 114-115.
[67] المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص88، وللمزيد عن هبوب الرياح الموسمية ودورها في تجارة المحيط الهندي، انظر سليمان عبدالغني المالكي: دور العرب وتأثيرهم في شرق أفريقيا، ص121– 125.
[68] بلاد السند: يُقصد بها الأرض التي تشغلها حاليا آراضي باكستان، وانظر ابن حوقل (ت: 350هـ/961م): صورة الأرض، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، طـ1، 2009م، ص294 وما بعدها.
[69] ابن حوقل: المصدر نفسه، ص149.
[70] المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص84.
[71] المسعودي: جـ1، ص88، وللمزيد عن الرحلات البحرية والرياح الموسمية، انظر:
www.chinatoday.com.cn
[72] جوردون تشايلد: ماذا حدث في التاريخ، ص274.
[73] فوه ين ده: تاريخ العلاقات الصينية العربية، ترجمة: تشانج جيا مين، انظر موقع الصين اليوم، وللمزيد في ذات الشأن انظر أيضاً: www.chinatoday.com.cn
[74] المسعودي: المصدر نفسه، ص88، وانظر أيضاً عطية القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت، ص23.
[75] مروج الذهب: جـ1، ص84. ويطلق ابن سعيد على هذا البحر أيضا في مواضع أخرى “بحر الهند” (ابن سعيد: كتاب الجغرافية، تحقيق: إسماعيل المغربـي، سلسلة ذخائر التراث العربـي، منشورات المكتب التجاري للطبـاعة والنشر، بيروت، 1970، ص83، وانظر العُمري: مسالك الأبصار، جـ1، ص105).
[76] ابن البلخي: فارس نامة، تحقيق: يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، طـ1، 1999م، ص149.
[77] المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص84.
[78] سليمان عبدالغني المالكي: دور العرب وتأثيرهم في شرق أفريقيا، ندوة مؤتمر العرب في أفريقيا الجذور التاريخية والـواقع المعاصر، كلية الآداب، جامعة القـاهرة، دار الثقـافة العربية، 1987م، ص123.
[79] المرجع السابق، ص123
[80] كرم الصاوي باز: التبادل التجاري بين شرق أفريقيا وآسيا كما يصورها البلدانيون العرب، ندوة مؤتمر التعاون العربي الأفريقي، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 2007م، ص5.